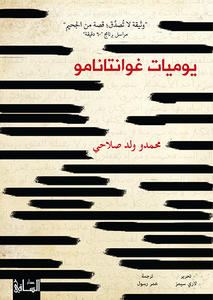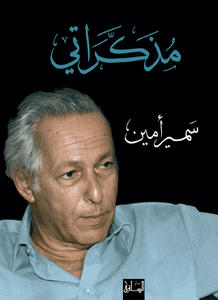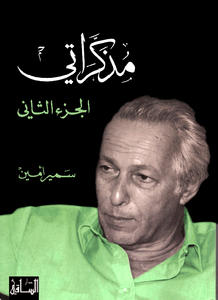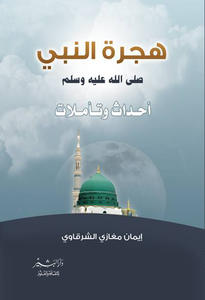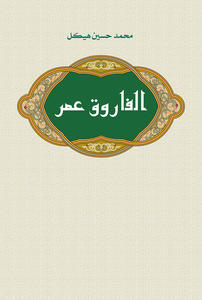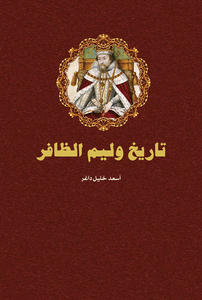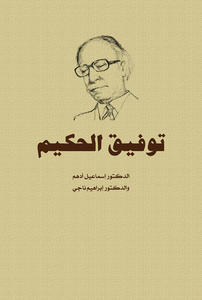-
يوميات غوانتانامو
حدث لم يسبق له مثيل في عالم النشر على الصعيد العالمي: للمرة الأولى، يكتب سجينٌ يومياته وهو لا يزال رهن الاعتقال في غوانتانامو. منذ عام 2002 وحتى هذه اللحظة، يقضي محمدو ولد صلاحي أيامه سجيناً في المعسكر الاحتجازي في خليج غوانتانامو بكوبا. وطوال هذه السنوات لم توجّه إليه الولايات المتحدة أيَّ نوع من التُّهم. أصدر قاضٍ من المحكمة الفيدرالية قراراً يقضي بإطلاق سراحه في مارس 2010، ولكنّ الحكومة الأميركية عارضت قراره ذاك، ولا توجد الآن أية إشارات في الأفق تدلّ على أنّ الولايات المتحدة لديها نية لإطلاق سراحه. في السنة الثالثة من أًسْره، بدأ صلاحي بكتابة يومياته، واصفاً فيها حياته قبل مغادرته بيته، في 28 نوفمبر عام 2001، واختفائه في سجن أميركي، ومن ثم «رحلته اللانهائية حول العالم» سجناً وتحقيقاً، وأخيراً حياته اليومية كسجين في غوانتانامو. يومياته ليست مجرد سجلّ حيّ لإخفاق العدالة، بل وذكريات شخصية رهيبة تتّسم بالعمق والسخرية السوداء واللطف المدهش.
يوميات غوانتانامو
محمدو ولد صلاحي
-
مذكراتي
عايش سمير أمين المحطات المفصلية والحاسمة في تاريخ العالم العربي: كان لا يزال طالباً في باريس يوم شهد انتكاسة العرب ونكبة 1948 التي تم فيها احتلال فلسطين، ثم عاش هزيمة 1967 وتداعياتها الخطيرة على مصير العالم العربي، برمّته، وبداية انهيار مشروع العرب السياسي والوحدوي. ثم قدّر له أن يشهد تفجيرات 11 أيلول/ سبتمبر وانعكاساتها، التي دفع العرب ضريبة باهظة لها، كان سقوط بغداد إحدى نتائجها المباشرة، وإحدى علامات موت المستقبل العربي في ما بعد أحداث نيويورك. في هذا الكتاب، يورد سمير أمين ذكريات من طفولته التي لم تكن طفولة عادية، وإنما عاش بعضاً منها في ظل حرب جعلته يكبر، ويهجر طفولته، قبل أوانه. ثم يتطرق إلى نشاطاته في فرنسا أيام كان طالباً فيها، والدور السياسي والاجتماعي الذي اضطلع به بين أبناء المستعمرات الذين كانوا لاجئين في فرنسا. كما يعالج الرؤية التنموية والاقتصادية التي حاول سمير أمين أن يطرحها على نطاق مصر، ومن ثم أفريقيا، من أجل النهوض بالاقتصاد وإيجاد السياسات المحفزة للتنمية واللحاق بركب الدول المتطورة.
مذكراتي
سمير أمين
-
مذكراتي - الجزء الثاني
بين السرد والتحليل، يقوم سمير أمين في هذا الجزء الثاني من مذكّراته بجولة حول العالم، يزور خلالها البلدان المختلفة ويبيّن ما يعتبره تفاصيل المشروع الإمبريالي، الأميركي تحديداً. مشروعٌ بدأ برأيه بعد مؤتمر بوتسدام، بالتحالف مع أوروبا واليابان المحتلّة. +++ التفوّق العسكري؛ الشركات المتعدّدة الجنسيات؛ الطبقات الحاكمة العميلة؛ نقد تطبيق الاشتراكية في الاتحاد السوفياتي والصين... ومن جهة ثانية، المناضلون اليساريون والمحلّلون التقدّميون، أصدقاء المؤلّف، وثورة دائمة لا تتراجع... هذا ما نقرأه في هذا الكتاب الزاخر بالوصف الجميل، والتحليل المبسّط، وحتى الأحداث الطريفة.
مذكراتي - الجزء الثاني
سمير أمين
-
هجرة النبى ﷺ
الهجرة النبوية هي حدث تاريخي وذكرى ذات مكانة عند المسلمين، ويقصد بها هجرة النبي محمد وأصحابه من مكة إلى يثرب والتي سُميت بعد ذلك بالمدينة المنورة؛بسبب ما كانوا يلاقونه من إيذاء من زعماء قريش، خاصة بعد وفاة أبي طالب، وكانت في عام 1هـ، الموافق لـ 622م، وتم اتخاذ الهجرة النبوية بداية للتقويم الهجري، بأمر من الخليفة عمر بن الخطاب بعد استشارته بقية الصحابة في زمن خلافته، واستمرت هجرة من يدخل في الإسلام إلى المدينة المنورة، حيث كانت الهجرة إلى المدينة واجبة على المسلمين، ونزلت الكثير من الآيات تحث المسلمين على الهجرة، حتى فتح مكة عام 8 هـ.
هجرة النبى ﷺ
إيمان مغازي الشرقاوي
-
الفاروق عمر
يستكمل محمد حسين هيكل سلسلة دراساته حول التاريخ الإسلامي، التي بدأها ﺑ «حياة محمد» و«الصديق أبو بكر»؛ حيث ينتقل المؤلف في كتابه «الفاروق عمر» لمناقشة حياة هذه الشخصية التاريخية البارزة، وذلك منذ ما قبل دخولها إلى الإسلام حتى توليها الخلافة عقب وفاة أبي بكر الصديق. وقد شهدت الخلافة الإسلامية على يدي عمر بن الخطاب الكثير من الإنجازات السياسية والاقتصادية والعسكرية التي تحققت خلال عشر سنوات فقط من فترة حكمه، حيث شهدت البلاد استقرارًا داخليًّا، وتوسعًا خارجيًّا شمل الشام والعراق وفارس ومصر، كذلك امتدت الإمبراطورية حتى حدود الصين من الشرق، وإفريقية من الغرب، وبحر قزوين من الشمال، والسودان من الجنوب.
الفاروق عمر
محمد حسين هيكل
-
تاريخ وليم الظافر
يؤرخ هذا الكتاب لحقبةٍ زمنية مهمة من تاريخ الدولة الإنجليزية مُمثَّلةً في شخص وليم الظافر، ذلك البطل المقدام الذي استطاع أن يُخْضِعَ الدولة الإنجليزية لقبضة سلطانه بحجة أنه هو الوريث الأصيل لعرش إنجلترا، وأن الملك الذي تربَّع على عرشها لم يكن ملكًا شرعيًّا لها. ويقصُّ لنا الكاتب التدرُّج المرحلي الذي مرَّ به وليم حتى اعتلى عرش نورماندي، ويجلي لنا السياسة التي كان ينتهجها وليم الظافر في حكم هذه الإمارة، والمؤامرات التي حِيْكَت له من لَدُن خصومه إبَّان حكمه لها، وقد برع الكاتب في صَوغ المقدرات الذاتية لتلك الشخصية، فلم يأسرها في صولجان المُلك بل صوَّر أطوارها ونوَّعها ما بين الحب والسياسة وسطوة الصراع على المُلْك.
تاريخ وليم الظافر
أسعد خليل داغر
-
تاريخ ابن خلدون
اهتم شكيب أرسلان في هذا الكتاب بتاريخ واحد من أبرز العلماء والفلاسفة في التاريخ الإنساني، وهو العلامة «ابن خلدون»، حيث وجد في كتابهِ المسمى بـ«كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر» درة علمية نفيسة تشكل أحد أعظم الكلاسيكيات الاجتماعية في التراث الإنساني، ويعتبر الكثير من العلماء أن ابن خلدون هو مؤسس علم الاجتماع الحديث، وفي الكتاب الذي بين أيدينا يتناول أرسلان هذا العمل الكلاسيكي بالشرح والتعليق والتطبيق.
تاريخ ابن خلدون
الأمير شكيب أرسلان
-
توفيق الحكيم
يعد هذا الكتاب عملًا نقديًّا رصينًا، وينقسم هذه العمل إلى قسمين؛ يشكل القسم الأول (الخاص بالدكتور إسماعيل أدهم) ذلك الجانب الأكبر منه، حيث يدرس فيه أدهم «توفيق الحكيم» بشخصه، وفنه دراسة أدبية تعتمد على طرائق البحث التحليلي والمنهجي، أما القسم الثاني فكتبه إبراهيم ناجي عن حياة توفيق الحكيم النفسية، وعقله الباطن، بما يحمله من جوانب خفية، كما يستعرض السياق التاريخي للنهضة الأدبية العربية، وكيف نشأت فيه هذه الشخصية الأدبية ذات الطراز الرفيع.
توفيق الحكيم
الدكتور إسماعيل أدهم والدكتور إبراهيم ناجي
-
كلِمات نابُليون
ترفض بعض المدارس التاريخيَّة التفسيرات البطوليَّة للتاريخ، والتي عادةً ما تتخذ من مفهوم البطولة محرِّكًا له، إلا إن قبول مثل هذه التفسيرات عند المدارس الأخرى له ما يبرِّره، فلا يمكننا أن نستبعد الخصائص الذاتيَّة الفريدة للشخصيَّة التاريخيَّة، والتي تسهم بقسطٍ كبير في سَيْر حركة التاريخ على نحو ما أرادت لها الذات الإنسانيَّة، كما لا يمكننا التعويل فقط على الظروف الاجتماعيَّة والسياسيَّة والاقتصاديَّة والعسكريَّة باعتبارها هي فقط ما يصنع التاريخ، وكأنَّ مفهوم الإرادة الإنسانيَّة غير موجود أو عاجز عن التحكُّم ولو بقَدْرٍ ما في مسار التاريخ. وفي هذا الكتاب يستعرض «إبراهيم رمزي» إحدى تلك الشخصيات العظيمة التي أثَّرت برأيه في تاريخ الغرب والشرق، وهي شخصية «نابليون بونابرت»؛ الإمبراطور الفرنسيُّ الشهير الذي تولى زمام الحكم في فرنسا، وكان له الأثر البالغ في التاريخ الحديث.
كلِمات نابُليون
إبراهيم رمزي
-
أبراهام لنكولن
أبراهام لنكولن رجل غيَّر مجرى التاريخ، ويعتبر المؤسس الثاني للولايات المتحدة الأمريكية. بدأ لنكولن حياته من كوخ بسيط بولاية «كنتاكي» فى ١٢ فبراير ١٨٠٩م، وقد عمل في عدة مهن منها؛ الصيد وتقطيع الأشجار والزراعة والتجارة والمحاماة. وأخيرًا قرر الانخراط في السياسة؛ حيث أصبح عضوًا بالكونجرس، ثم أصبح رئيسًا للجمهورية فى انتخابات ١٨٦٠م. كانت فترة رئاسته عصيبة؛ فقد أصر على إلغاء الرق؛ مخلدًا اسمه في التاريخ؛ الأمر الذي دفع بإحدى عشرة ولاية جنوبية للانفصال؛ فدخل حربًا ضروسًا لإعادتها إلى الاتحاد، لكنه لم يعش طويلًا ليهنأ بنصره، حيث تم اغتياله عام ١٨٦٥م، وصدق لنكولن حينما قال معظم الرجال تقريبًا يمكنهم تحمل الصعاب، لكن إن أردت اختبار معدن رجل فاجعل له سلطة.
أبراهام لنكولن
محمود الخفيف