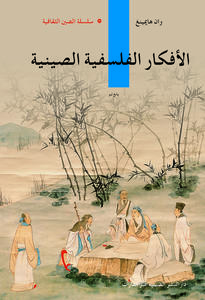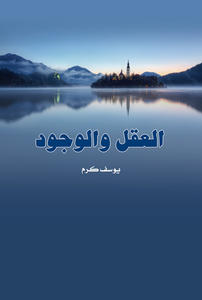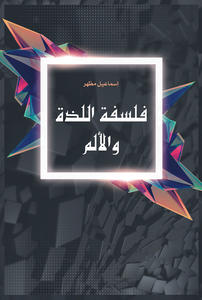-
الفلسفة ببساطة
في هذا الدليل الحيوي المعبر تعود الفلسفة إلى الحياة. وباستخدام فكرة السببية المركزية كمبدأ إرشادي، يبيّن برندان ولسون كيف يصبح تاريخ الفلسفة تسلسلاً واضحاً وطبيعياً للأحداث. وتكشف وجهة النظر، الناتجة عن ذلك، الروابط العميقة بين مشاكل العلم والعقل والحقيقة والحرية والمسؤولية والمعرفة واللغة والحقيقة والدين. +++ سيتمكن المقاربون الجدد للفلسفة من التعاطي مع الأسئلة والأفكار العظيمة في العرف الغربي. الكتابة واضحة وخالية من الإبهام، بينما تعطي بنية، الفصل-القصير، القارئ، الوقت للتوقف والتفكير في كل خطوة على مسار الطريق. تمهد رشاقة الأسلوب وجزالة التنسيق، أولاً، إلى سهولة الوصول: كما أن التوضيحات تشمل الرسوم والمخططات البيانية فضلاً عن صور الفلاسفة من أرسطو إلى فيتكينشتاين.
الفلسفة ببساطة
براندون ولسون
-
ايدلوجيا الفلسفة الصينية (سلسلة الثقافة الصينية) (باللغة العربية)
ايدلوجيا الفلسفة الصينية: يتناول الكتاب الأفكار الفلسفية الصينية منذ أسرة تشين وحتي الآن، لتكون الخيط الذي يعرض تطور الأفكار الفلسفية الصينية، واستعرض الكتاب الأفكار الفلسفية الصينية التقليدية، ومن ثم عمد إلى التركيز على السمات الفلسفية لكافة المدارس الفلسفية في مختلف المراحل التاريخية، واقتباس أصنافا من الفلسفة الغربية، ومن ثم لخص الفلسفة السياسية لأسرة تشين وما وراء الطبيعة لأسرتي هان وتانغ والنظريات المعرفية لأسرتي سونغ ومينغ. وقد بذل الكاتب جهودا مضنية من أجل شرح الأفكار الفلسفية العميقة لكافة الفلاسفة وكافة العصور المختلفة شرحا بسيطا وسلسا، وقد وصف الكاتب العديد من الأسئلة الفلسفية الصعبة بطريقة أكثر تصويرية.
ايدلوجيا الفلسفة الصينية (سلسلة الثقافة الصينية) (باللغة العربية)
وين هاي مينغ
-
أحلام الفلاسفة
يضم هذا الكتاب بين دفتيه أروع أحلام فلاسفة العالم، إنه الحلم الذي يحيا من أجله الإنسان حتى الآن «اليوتوبيا» أو «المدينة الفاضلة». ذلك الموضوع الذي أُثير منذ أمدٍ بعيد؛ فقد ابتدأه «أفلاطون» في العصور القديمة ثم «توماس مور» في عصر النهضة، وتوالت الأحلام والأفكار حتى الآن، كلٌّ منهم يؤسس مدينته ويضع أسس نظامها، وقد اختار هؤلاء الفلاسفة النظام «التضامني»، فتارة يكون هناك اشتراك فى ملكية رأس المال، وتارة أخرى نراه اشتراكية في مواجهة الثورة الصناعية، ثم شيوعية في مواجهة الرأسمالية، وأخيرًا يجيء الحلم المصري «خيمى» الذي يسعى فيه «سلامة موسى» أن يؤسس يوتوبيا مصرية. حقًّا اختلف الفلاسفة في تحديد اسم المدينة، ولكنهم اتفقوا في الحلم.
أحلام الفلاسفة
سلامة موسى
-
آراء أناتول فرانس
كان أناتول فرانس — أحد أعلام الأدب الفرنسيِّ في القرن التاسع عشر — أديبًا من الطراز الرفيع؛ فمجموع ما تركه من مؤلفات وأعمال أدبية يكشف عن تحلِّيه بموسوعيَّة هائلة ضاهى بها مفكِّري عصره. وقد برز في كتاباته طابع فلسفيٌّ واجتماعيٌّ خاص، وروح حكيمة ومرحة في آنٍ واحد، فضلًا عن قدرته على سبر أغوار النفس البشرية، واستنطاق الطبيعة والكون بأسره. ولمَّا كان إعجاب عمر فاخوري بالأديب الفرنسيِّ عظيمًا، وكانت فجيعته في وفاته سنة ١٩٢٤م عظيمة هي الأخرى، فقد أراد أن يقدِّم لقراء العربيَّة قبسًا من أفكار أناتول وآرائه، بما تضمَّنته من قضايا النفوس والأرواح، والحياة والموت، والحقيقة والخرافة، والعلم والدين، والماضي والمستقبل، والتمدُّن والوحشيَّة، والحبِّ والغواية. إنه واحدٌ من الكتب التي تمتع القارئ وتحمله على الفكر والتفكُّر.
آراء أناتول فرانس
عمر فاخوري
-
الكون والفساد
«الكون والفساد» كتاب يضم بين دفتيه أفكار فلاسفة اليونان القدامى من أقدم العصور وحتى عصر أرسطو؛ حيث يتناول أرسطو الآراء السابقة التي ناقشت الكون ومكوناته، والأجسام وماهيتها وفسادها؛ فيقوم بتشريح هذه الآراء، كما يعرض الأسس التي قامت عليها نظريته، ثم يَصُوغ هذه النظرية في قالب فلسفي بديع. كما يحتوي الكتاب على ثلاث رسائل موجَّهة إلى كبار معارضيه، وهم: «ميليسوس»، و«إكسينوفان»، و«غرغياس»، حيث يتناول نقدَ نظرياتهم المتعلِّقة بالكون، والنظرية الوجودية، كما ناقش فكرة وحدانية الله. وقد كان لهذا الكتاب عظيم الأثر على فلاسفة المسلمين في العصر الوسيط، حيث تُرجم لأول مرة على يد «ابن رشد»؛ الذي لقَّبَه «دانتي» ﺑ «الشارح الأكبر لأرسطو».
الكون والفساد
أرسطوطاليس
-
العقل والوجود
يُبرِز لنا الكاتبُ في هذا الكتاب أهميةَ الدور المحوري الذي يلعبه العقل في إدراكِ الموجوداتِ التي يُعنَى بها مبحث الأنطولوجيا «مبحث الوجود» باعتباره أحد المباحث الفلسفية الأساسية، ويتفق الكاتب مع وجهة النظر الفلسفية القائلة: إن المعرفة العقلية أرقى من المعرفة الحسيةِ، وذلك باعتبار أن العقل جارحةٌ إنسانية تمتلكُ قوةً تُمكِّنها من إدراكِ أنماط شتى من المعارف اللامادية، ويربط الكاتب بين الموجودات والدور الذي يلعبه العقل في إدراكِ هذه الموجودات؛ وذلك باعتبار أنَّ العقل هو الرئيس المدبر لشئون الحكم في الموجودات من نباتاتٍ وحيوانات وغيرها؛ أي: إنه هو القاضي الذي يمتلكُ القول الفصل في الحكم على الموجودات وما تتفرع إليه من مبادئ وأقسام.
العقل والوجود
يوسف كرم
-
فلسفة اللذة والألم
تُعَدُّ قضية المركز أو «اللوجوس» هي القضيَّة الأساسيَّة في دراسة التراث الفلسفي، فلا توجد فلسفة دون مركز؛ لذلك تتعدَّد المدارس والمذاهب الفلسفيَّة بتعدد مراكز التحليل الفلسفيِّ وبؤر التحليل المعرفي، ويُعَدُّ هذا الكتاب إطلالة مميَّزة على أحد هذه المذاهب التي جعلت من اللذة والألم بؤرة للتحليل ومركزًا تنطلق منه حياة الإنسان. وتُنْسب بدايات هذا المذهب إلى الفيلسوف اليوناني «أبيقور» الذي كان يقول بأن اللذة هي غاية الحياة، وأن المعرفة لا تتحقق إلا بالحواس، وقد انشغل «إسماعيل مظهر» بتأليف هذا الكتاب مدة أربع سنوات كاملة، تابع خلالها أصول هذه المدرسة الفلسفية وتطوُّرها عبر التاريخ.
فلسفة اللذة والألم
إسماعيل مظهر
-
خطرات نفس
«خطرات نفس» هي مجموعة من المقالات التي أودعها الكاتب زهرة العمر، وباكورة أيام الصبا؛ فهو يستعير من الذكريات فلسفة مشاهدة الحياة؛ فلا يقتصرُ في سردها على مشاهد مجرَّدة أوجدتها الذكريات؛ ولكنه يتخذ من كل خاطرةٍ له قصة يبثُ فيها قيمة من قيم الوجود الإنساني: كالإيثار، والتسامح، والرضا، والتواضع. ومَنْ يقرأ هذا الكتاب يجد أنه أمام دستورٍ صغير من دساتير تهذيب النفس الإنسانية؛ لأن كاتبها قد صبغها بصِبغَةٍ من مقدرات الحياة النفسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والدينية؛ فقد وفِق الكاتب في كتابة ذكريات جمعتها نفس واحدة، وعوالم متفرقة؛ فهو يخترق حاجب النفس الإنسانية لِيُطْلِقها عبْرَ مشاهداتٍ أرحب نحو آفاق الحياة، ولا عجب في ذلك؛ لأن أكرم قسمٍ في ذكريات التاريخ الإنساني، هي الذكريات التي تُخَطُّ بأنامل النَّفس.
خطرات نفس
الدكتور منصور فهمي
-
خواطر حمار
في عالم لا يحترم حقوق الإنسان ولا يقيم للإنسانية وزنًا، هل نتوقع أن يحمل للحيوانات أي تقدير؟ من هذا المنطلق تأخذنا الأديبة الفرنسية «دي سيجور» لأعماق النفس الحيوانية، لتسجل في كتابها خواطر تمثل ما يمكن أن يقوله الحمار لنا لو أُتِيحَت له الفرصة للحديث معنا. الحمار «كديشون» يريد أن يمحو من ذاكرة الإنسان ما أُشِيع عن الحمار من أنه غبي وكسول وسيئ التصرف، فعلى العكس من ذلك أثبت «كديشون» أنه أذكى كثيرًا من الإنسان، حتى إنه لُقِّب بـ«الحمار العالِم». ويقوم الحمار بعدد من المغامرات التي تظهر فيها قدرته على المكر وخداع الإنسان، كما يقدِّم نفسه كشجاع يخاطر بحياته لينقذ صديقته المقربة. إن «خواطر حمار» سيغير الكثير من مفاهيمنا السابقة عن ذلك الحيوان التعس.
خواطر حمار
الكونتيسة دي سيجور
-
الآراء والمعتقدات
يُفصِّل الكتابُ علاقة المرءِ بالمعتقد والرأي الذي يؤمن به؛ فعلى مدار تسعة أبواب يُثير المؤلِّف أسئلة تتكشف مع محاولات الإجابة عليها؛ فيوضِّح الفروق بين الآراء والمعتقدات من جهة، والمعرفة من جهة أخرى، إضافة إلى شرح آليات ومظاهر التأثُّر بالرأي والمعتقد، سواء من باب الأثر النفسي الواقع أو اللذة المتوقعة، كما يشرح الكتاب أنواع الغرائز وما يحرِّكنا ناحية معتقداتنا وآرائنا، ويُفصِّل آلية عمل هذه المحركات، وأسباب التصادم والتنازع بينها داخل المجتمعات، وآليات التوفيق أيضًا. ويوضِّح بالشرح مفهوم الرأيِ الفرديِّ، مبيِّنًا مظاهر الخصوصيَّة من فرد لآخر، والمؤثرات الخاصَّة على الفرد في هذه المسألة. ، ثم يتعرَّض لنفس المشكلات في آراء المجموع. ، لينتقل بعد ذلك إلى شرح آليات انتقال الرأي وانتشاره، والوسائل المستخدمة في الترويج للآراء والمعتقدات في المجتمعات. ، ثم يقدِّم مباحث تجريبية في تكوين المعتقدات وما ينشأ عنها من حوادث غير شعورية.
الآراء والمعتقدات
غوستاف لوبون